جدلية العلاقة بين اللغة والفكر
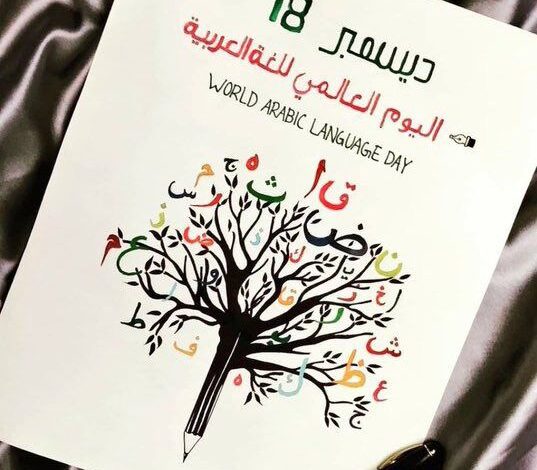
على كفتي ميزان ترتكز اللغة والفكر؛ إذ لا يمكن ترجمة الفكر بلا لغة، ولا أهمية حقيقية للغة ليست مفكّرة. تعد العلاقة بين اللغة والفكر من المواضيع الفلسفية الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً عبر الزمان فهي حسب الناقد الكندي “فراي” نظام مرّ بأطوار ثلاثة، كل طور فيها يشكّل نظامًا معرفيا يملي على العقل الإنساني آليات محددة في التفكير، وقد نلخص ما جاء في كتابه” المدوّنة الكبرى” أطوار اللغة بمراحلها: “الطور الاستعاري والكنائي والوصفي. فشرح الاستعاري كما قال الجرجاني بأن نظام الاستعارة الذي يقوم على المماثلة والكناية، وهو أن نترك الشيء ونأتي إلى تاليه وردفه في الوجود. فخلص إلى نتيجة أن المجتمعات القديمة كانت تفكر داخل نظام لغوي يقوم على الاستعارة كعنصر تكويني في الأدب، حيث لا توجد مسافة بين الكلمة والشيء الذي تدل عليه بل تلتحم الذات بالموضوع والدال بالمدلول.
والطور الثاني الكنائي، تطور منذ سقراط وأفلاطون كنوع آخر من النظام اللغوي القائم على تجريد العلاقة بين الكلمات والأشياء بمعنى مطابقة الحياة بين الإنسان والطبيعة لتصبح الكلمات تدل على الأفكار وهي التعبيرات الخارجية لواقع داخلي، فاللغة الكنائية تميل إلى كونها لغة تمثيلية مباشرة أو محاكاة لفظية لواقع يتخطى ذاته لا يمكن أن تنقله إلا الكلمات.
أما الطور الثالث هو طور وصفي بدأ في عصر النهضة، حيث صار الواقع خارج نفسه متمثلًا في الطبيعة ومعيار لسلامة الأبنية العقلية والمنطقية واللغوية، فمن الناحية القواعدية لا فرق بين وحيد القرن والأسد، أما مسألة الوجود الفعلي لا تدخل في نسق ترتيب الكلمات، ومادامت لا تدخل فلا يمكن أن يوجد فرق بين الاستدلال والاستنتاج مادام كلا الإجراءين يرتب الكلمات بالطريقة ذاتها فهي وصفية”.(1)
لمن يكون السبق إذن: اللغة أم الفكر؟ وما هو الأساس الذي تتشكل منه اللغة؟ في هذا المقال، نستعرض بعض الآراء الفلسفية المهمة حول هذه المسألة ونحاول فهم تعقيداتها.
اللغة هي جسر الأرواح وصوت العقل. تُنسج من حروفها عوالم من المعاني، تربط الماضي بالحاضر، وتصوغ أفكار الإنسان وتعبّر عن مكنوناته بأسلوب فريد يميّز كل ثقافة ومجتمع، عرفها ستراوسن بأنها المظهر الخارجي للفكر.
تُعرَّف اصطلاحًا بأنها نظام من الرموز الصوتية أو الكتابية التي تعبّر عن الأفكار والمشاعر، وتُستخدم كوسيلة للتواصل بين أفراد المجتمع. تتميز اللغة بخصائص مثل القواعد النحوية، والدلالات، والصوتيات، مما يجعلها أداة لنقل المعاني وتنظيم الفكر الإنساني.
أما الفكر، فقد اتُفق على أنه عملية عقلية يتم من خلالها تحليل المعلومات، وتفسير الظواهر، واستنتاج المعاني بهدف الوصول إلى فهم أعمق للواقع أو اتخاذ القرارات. إنه نشاط ذهني يعتمد على الإدراك والتأمل والاستدلال.
في المقابل، الفكر هو نبض العقل وإشراقة الروح، ورحلة لا حدود لها في عوالم المعاني والمعرفة. يبحر بالإنسان نحو الحقيقة، ويمنحه القدرة على الإبداع والتغيير، وصياغة رؤى جديدة للحياة.
تعد جدلية العلاقة بين اللغة والفكر من القضايا الأساسية التي ناقشها الكثير من الفلاسفة عبر التاريخ، وأحد الأبعاد المهمة لهذه الجدلية هو مسألة الحضور الآني (الحدث) أي عندما يطرأ أمر مفاجئ أو جديد، هل يسبق الفكر اللغة أم أن اللغة هي التي تسبق الفكر في التعبير عن هذا الحدث؟
قد يبدو من هذا المنظور أن الفكر هو الأساس، وأن اللغة مجرد أداة تعبر عنه. بمعنى أن الفكرة تتشكل أولاً في العقل، ثم تأتي اللغة كوسيلة لتوضيحها أو نقلها إلى الآخرين.
وانقسم الفلاسفة في آرائهم إلى ثلاثة أقسام:
الفريق الأول ذهب إلى أن الفكر هو الأساس الذي يتحكم باللغة مثل ديكارت، والفريق الثاني غلّب اللغة على حساب الفكر وجعل لها الأسبقية، أما الفريق الثالث ذهب إلى تبني رأي أن الفكر واللغة يسيران معًا.
حسب الفريق الأول الفلاسفة العقلانيين، يرى ديكارت أن الفكر مستقل عن اللغة، له الأسبقية وأن الإنسان يمكن أن يفكر حتى في غياب اللغة عند وقوع حدث معين، وأن العقل يدرك أولاً ما يجري، ثم يعبر عنه بلغته. أي أن الفكرة موجودة والكلمات تجسدها.
يتفق معه الفيلسوف جوتلوب فريجه بأن الفكر يمكن أن يوجد بشكل مستقل عن اللغة. ويرى أن الأفكار المجردة تتشكل قبل أن يتم التعبير عنها لغويًا، فيعزز بذلك فكرة أن التفكير يسبق اللغة كون الأطفال يفكرون ويدركون العالم من حولهم قبل أن يتعلموا الكلام، ولديهم القدرة على التفاعل مع البيئة وإظهار مظاهر التفكير حتى قبل اكتسابهم للغة، مما يشير إلى وجود نوع من التفكير يسبق اللغة بمعنى أن الأهمية تكون في توضيح الفكرة قبل إيصالها، مثال: عند مشاهدة انفجار مفاجئ، قد يفكر الشخص أولاً: “ما هذا الشيء الخطير؟”، ثم يعبر عن ذلك بقوله: “انفجار!”. الفكرة هنا سبقت اللغة.
ولكن الفريق الثاني من الفلاسفة مثل فيتجنشتاين ومارتن هايدجر وهيجل، يرون أن الفكر لا يمكن أن يوجد بمعزل عن اللغة لأن اللغة تسبق الفكر وهي التي تحدد حدود الفكر. وفقًا لهذا الرأي، تكون اللغة ليست مجرد أداة للفكر، بل هي الإطار الذي يتشكل فيه الفكر بمعنى أن الشخص لا يمكنه التفكير في شيء إلا إذا كانت لديه كلمات يعبّر بها عنه. ففي اللحظة التي يقع فيها حدث مفاجئ، تكون اللغة هي من يمنح الفكر شكله وتجعله ممكنًا. في نفس المثال: عند وقوع نفس الانفجار، الشخص قد يهتف فورًا: “انفجار!”، وهنا تكون اللغة هي الوسيط الذي صاغ الفكرة وأعطاها شكلاً وبهذا يؤكد الفيلسوف الألماني “هيجل” أن اللغة هي التي تمنح الفكر بنيته وقوته، فيقول في كتابه فلسفة الروح: “لا يمكن للفكر أن يتبلور ويأخذ شكله الكامل إلا من خلال اللغة، فنحن نفكر من خلال الكلمات.” وهذا يعني بمنظورهم أن اللغة ليست مجرد أداة للتعبير أو وسيلة للتواصل، بل هي الوسيلة التي بواسطتها يمكن للفكر أن يتطور ويتعمق كجزء لا يتجزأ منها.
وهناك من يرى أن إشكالية اللغة والفكر مرتبطان بشكل جدلي، بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، كأنهما وجهان لعملة واحدة. تقول العرب:” من صح عقله صح لسانه”، وأن أحدهما يعتمد على الآخر. تبنى هذا الرأي إيمانويل كانط، كذلك الفلاسفة البنيويين مثل رولان بارت، بمعنى أنه عند وقوع حدث يتفاعل الفكر واللغة في اللحظة ذاتها، فلا يمكن القول إن أحدهما يسبق الآخر، لأن اللغة هي التي تمنح الفكر شكله، والفكر هو الذي يفعّل اللغة. مثال: عند رؤية الانفجار، الشخص قد يشعر بالخوف أو الدهشة، وهذه المشاعر تتجلى فورًا في كلمات مثل: “كارثة!” أو “ما هذا الذي حدث!”. هنا، الفكر واللغة يعملان معًا بشكل متزامن.
في جدلية الحضور الآني للحدث، الإجابة تعتمد على المنظور الفلسفي الذي يتم تبنيه. مَن يرى أن العقل هو الأساس، يرجّح أن الفكر يسبق اللغة. أما من يعتقد أن اللغة هي الإطار الذي يجعل الفكر ممكنًا، يرى أن اللغة تسبق الفكر. وفي النهاية، قد يكون من الأدق القول إنهما يعملان معًا في تكامل جدلي ليبقى السؤال الأكثر إثارة: هل يمكن للفكر أن يوجد بمعزل عن اللغة؟ وهل تؤثر اللغة في طريقة تفكير الأفراد وفهمهم للعالم؟ وكيف تؤثر اللغة في طريقة التفكير؟
من زاوية أخرى نجد أنه يمكن للغة أن تشكل حدود الفكر وتؤثر على تصوراتنا للعالم. ومن النظريات البارزة في هذا السياق فرضية “النسبية اللغوية” التي قدمها العالمان “إدوارد سابير” و”بنجامين وورف” حيث تنص هذه الفرضية على أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير عن الأفكار، بل هي إطار يحدد كيفية تكوين هذه الأفكار.
لهذه الفرضية مستويان رئيسيان:
-الحتمية اللغوية (Linguistic Determinism):
تقول هذه الفرضية إن اللغة تُحدّد تمامًا طريقة التفكير. أي أن الإنسان لا يستطيع التفكير في شيء لا تملكه لغته.
مثاله: بعض اللغات ليس لديها كلمات للتعبير عن الزمن (مثل الماضي والمستقبل)، وبالتالي فإن طريقة تفكير من يتحدث بها قد تختلف عن متحدثي لغات أخرى تملك هذا النوع من التعبيرات.
-المستوى الثاني هو النسبية اللغوية (Linguistic Relativity):
ترى هذه الفرضية أن اللغة تؤثر على التفكير، لكنها لا تقيّده بالكامل. فالبشر الذين يتحدثون لغات مختلفة قد ينظرون إلى العالم بطرق مختلفة، لكنهم يظلون قادرين على التفكير خارج حدود لغتهم.
ليف فيغوتسكي يدعم رأي كانط ويقدّم رؤية وسطية تفاعلية تجمع بين الطرحين السابقين، حيث يرى أن اللغة والفكر يتطوران بشكل متزامن ويتفاعلان باستمرار. يبدأ فيها الفكر في التطور بشكل مستقل، ثم يتأثر لاحقًا باللغة، مما يؤدي إلى تفاعل دائم بين الاثنين. يركز فيغوتسكي على دور اللغة في النمو المعرفي والاجتماعي، ويثبت أن اللغة ليست فقط وسيلة لنقل المعرفة، بل هي أيضًا أداة لتشكيل الفكر وتطويره من خلال الحوار والتفاعل الاجتماعي.
في أمثلة واقعية يمكن أن تتجلى العلاقة بين اللغة والفكر، وتوضح كيف يمكن للغة أن تؤثر على إدراك الأفراد للعالم من حولهم :
– تمييز الألوان:
بعض اللغات تميز بين ألوان معينة أكثر من غيرها. مثلاً، اللغة الروسية لديها كلمات منفصلة للأزرق الفاتح والغامق، مما قد يجعل الناطقين بها أكثر قدرة على التمييز بين درجات الأزرق مقارنة بالمتحدثين بالإنجليزية، حيث يتم استخدام وصف إضافي مثل “أزرق فاتح” أو “أزرق غامق”.
– تصور الزمن:
بعض اللغات تصف الزمن بطرق مختلفة. مثال: اللغة الماندارينية تستخدم مصطلحات رأسية (مثل فوق وتحت) للإشارة إلى الماضي والمستقبل، مما يؤثر على تصور المتحدثين عن الزمن مقارنة باللغات التي تستخدم إشارات أفقية (مثل أمام وخلف).
– إدراك الاتجاهات:
بعض لغات السكان الأصليين في أمريكا تركز على الاتجاهات الجغرافية (شمال، جنوب) بدلاً من الاتجاهات النسبية (يمين، يسار). هذا الاختلاف يظهر كيف يمكن للغة أن تؤثر على طريقة إدراك الأفراد للمكان والتنقل فيه.
بين فرضية النسبية اللغوية التي تؤكد تأثير اللغة على الفكر، وآراء الفلاسفة التي ترى في الفكر استقلالية عن اللغة، يظهر أن العلاقة بينهما ليست علاقة خطية (أي أن أحدهما يسبق الآخر)، بل هي علاقة تأثير متبادل حيث تلعب اللغة دورًا أساسيًا في تشكيل الفكر، تتطور استجابةً لاحتياجات الفكر المستمرة. فاللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بقدر ما هي أداة لتشكيل الهوية الثقافية والمعرفية.
والشعر هو أحد أكثر الأشكال تعقيدًا وغموضًا في العلاقة بين اللغة والفكر، لأنه يتجاوز التعبير العادي إلى مستوى أعمق من التصوير والتجسيد. عندما نتحدث عن “الاستحضار الشعري”، فإننا نتحدث عن لحظة مكثفة، حيث تتفاعل اللغة والفكر في آنٍ واحد لإنتاج صورة شعرية نابعة من حدث ما أو تجربة شعورية.
فكيف تتشكل العلاقة بين اللغة والفكر في استحضار الصورة الشعرية؟
في الشعر، الاستحضار ليس مجرد تذكُّر آلي لتجربة أو صورة من الماضي، بل هو إعادة خلق للحظة باستخدام أدوات اللغة نرى من خلالها أن الفكر واللغة يتداخلان بحيث يصعب الفصل بينهما. الفكر يستحضر التجربة (الحدث أو الشعور)، واللغة هي الوسيط الذي يمنحها حضورًا جديدًا، ليس فقط كما وقعت، بل كما يشعر بها الشاعر في لحظة كتابتها.
وقد يُكرَس الاستحضار لفهم العلاقة بين اللغة والفكر فيكون الفكر مصدر للصورة الشعرية يعمل كالبذرة التي تغذي اللغة عندما يكون الحدث داخليًا (شعورًا أو ذكرى) أو خارجيًا (مشهدًا أو موقفًا) يستدعيه الفكر ويعيد تشكيله. لكن الصورة الشعرية لا تصبح فعّالة إلا عندما تُصاغ بلغة تخلق تأثيرًا جديدًا.
مثال: لنفترض أنه هناك شعور مفاجئ بحنين إلى الطفولة عند رؤية طائر مهاجر. الفكر هنا يستحضر صورة الطائر كرمز للحرية أو الرحيل، ولكن اللغة هي التي تمنح هذه الفكرة شكلًا شعريًا:
طائرٌ يعبرُ الأفقَ
يتركُ غبارَ جناحيهِ في قلبي
كأنني وطنٌ لم يغادره أحدٌ قط.
في هذا المثال، الفكر استحضر الطائر كرمز، لكن اللغة أضافت طبقات من المعنى تتجاوز الفكرة الأصلية: الغبار (أثر الرحيل)، القلب (مكان الحنين)، الوطن (الهوية والشعور الداخلي).
كذلك في لحظة وقوع حدث معين، الاستحضار الشعري يكون أشبه بوميض، حيث الفكر واللغة يعملان معًا بشكل متزامن. فقد يفاجئ الشاعر بصورة أو عبارة تتشكل في ذهنه أثناء الحدث نفسه، فيشعر أن اللغة تكثف التجربة وتُعيد خلقها فورًا. مثلا إذا هطلت أمطارًا غزيرة في لحظة شعورية خاصة، قد تستحضر صورة شعورية مباشرة:
المطرُ يكتبُ على نافذتي
قصائدَ بكر
لم يقرأها الوجود بعد.
تُترجم اللحظة (الحدث) مباشرةً إلى صورة شعرية، حيث الفكر واللغة يعملان معًا لخلق استعارة تجمع بين المطر والكتابة. نخلص إلى حالة الشعر الذي يستحضر اللحظة بشكل متزامن، فنقول إن العملية جدلية حيث الفكر واللغة يتفاعلان معًا لإنتاج الصورة الشعرية في لحظة واحدة. طالما أن الشعر حالة استحضار مكثفة، يتحول الحدث أو الشعور إلى تجربة لغوية تُعبّر عن الفكر والوجدان معًا، واستحضار الصورة الشعرية يتطلب انسجامًا بين اللغة والفكر، بحيث تصبح اللغة وسيلة لتكثيف الفكرة، والفكرة مصدرًا لإبداع اللغة.
في العموم، يُعتقد أن التفكير متعالٍ وسابق اللغة التي تعتبر وسيلة أو أداة ولكن للّغة أيضًا دورها في أسبقية الوجود، وقد حسم روسو في كتابه (خطاب في أصل التفاوت) أنه: ” إذا كان الناس في حاجة للكلام لكي يتعلموا التفكير، فهم بحاجة أكثر لمزيد من المعرفة في التفكير لكي يتعلموا من فن الكلام”. وفهم هذه العلاقة يساهم في تعزيز التواصل والتفاهم بين الثقافات المختلفة. اللغة تمنحنا القدرة على التعبير عن أفكارنا ومشاركتها، بينما يمنحنا الفكر القدرة على التحليل والتفكير النقدي. لذلك، سواء كانت اللغة تسبق الفكر أم العكس، فالتطور يكون متماثلًا في اللغة والتفكير، وإن توافقهما يشكل نهجًا متكاملاً لفهم العالم وإثراء التجربة الإنسانية.
—
الهوامش والتعريف بالفلاسفة: بمساعدة الذكاء الاصطناعي:
1- نورثراب فراي: المدونة الكبرى الكتاب المقدس والأدب، ترجمة سعيد الغانمي، منشورات الجمل، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ص 5-13، بتصرف.
. إدوارد سابير (Edward Sapir) وبنجامين لي وورف (Benjamin Lee Whorf):
عالما لغة أمريكيان اشتهرا بطرح “فرضية النسبية اللغوية” التي تشير إلى أن اللغة تؤثر بشكل كبير على طريقة تفكير الأفراد وإدراكهم للعالم.
– مرجع: كتاب “Language, Thought, and Reality” لبنجامين وورف.
0 جوتلوب فريجه (Gottlob Frege):
فيلسوف ألماني ومؤسس المنطق الحديث. اشتهر بعمله في الفلسفة التحليلية، ورأى أن اللغة ليست شرطًا لوجود الفكر، بل وسيلة للتعبير عنه.
– مرجع: كتاب “The Thought: A Logical Inquiry” لجوتلوب فريجه.
0هيجل (Georg Wilhelm Friedrich Hegel):
فيلسوف ألماني بارز في الفلسفة المثالية. اعتبر أن اللغة ضرورية لتكوين الفكر، وأكد على أن الفكر لا يكتمل إلا من خلال اللغة.
– مرجع: كتاب “Phenomenology of Spirit” لهيجل.
0 ليف فيغوتسكي (Lev Vygotsky):
عالم نفس روسي اشتهر بنظرياته حول التطور المعرفي والاجتماعي. رأى أن اللغة والفكر يتطوران معًا في تفاعل مستمر، وأن اللغة أداة لتشكيل المعرفة.
– مرجع: كتاب “Thought and Language” لليف فيغوتسكي.
